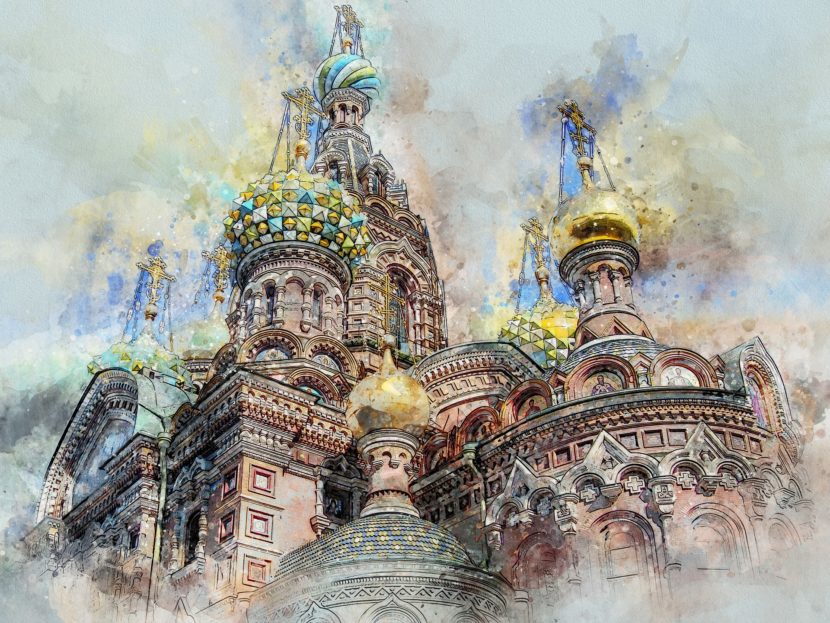لا يوجد الكثير من المراجع الأكاديمية الجادة التي تتناول اللاهوت الشرقي الأرثوذكسي في ضوء الكتاب المقدس والتعليم الأصيل للإصلاح الإنجيلي. تناولنا في المقال الماضي عن معنى التأله وأنه عملية مستمرة، كما تناولنا الحديث عن وسائله المختلفة. في هذا المقال سنتناول الحديث عن التبرير والتقديس بين العقيدة الشرقية الأرثوذكسية واللاهوت المصلح.
التبرير والتقديس
في تقيمي للفهم الأرثوذكسيِّ للخلاص، يجب أن أبدأ بالتأكيد أنَّ هذا الفهم ليس غريبًا على الفهم الإنجيليِّ بالقدر الذي قد نتصوَّره في البداية. فنحن أيضًا ننظر إلى الخلاص على أنَّه عمل الروح القدس الذي يتحقَّق بالنعمة. وبغضِّ النظر عن مدى استيائنا من التركيز الأرثوذكسيِّ على الأسرار، لكنَّنا أيضًا نؤكِّد أنَّ المعموديَّة وعشاء الربِّ يمثِّلان غفران الخطايا والحياة الجديدة والاشتراك في المسيح (مع أنَّ بعضنا يفضِّل أن يقول إنَّ الفرائض أو الأسرار ترمز إلى الحقيقة الروحيَّة، ولا تمنح بالفعل تلك الحقيقة). والإصرار الأرثوذكسيُّ على أنَّ الخلاص يشمل جهدًا بشريًّا ربَّما لا يكون رفضًا لإيماننا بالخلاص بالإيمان وحده، بل قد يكون بالأحرى شبيهًا بتأكيدنا (جزئيًّا، بناءً على فيلبِّي 2: 12 ويعقوب 2: 14-26) أنَّ الإيمان الحقيقيَّ يجب أن يثمر أعمالًا صالحة. فإنَّ طبيعة التألُّه، حسبما يفهمها الأرثوذكسيُّون، متوافقة مع الفكر الإنجيليِّ، مع أنَّ كلمة “تألُّه” نفسها قد تدفعنا إلى الظنِّ بأنَّها ليست كذلك.
ومع ذلك، فإنَّ تركيز الأرثوذكسيَّة على التألُّه أو التقديس على حساب استبعاد التبرير، يثير مشكلات خطيرة للإنجيليِّين الغربيِّين. فمن منظورنا، التبرير (باعتباره حكم الله ببرِّ الخاطئ) ليس مجرَّد فكرة غربيَّة يَكمُن أصلها في أسلوبنا القضائيِّ في النظر إلى الواقع، لكنَّنا على قناعة بأنَّها فكرة كتابيَّة، بل وواحدة من أهمِّ الحقائق على الإطلاق في الكتاب المقدَّس. وبموجب ذلك، يليق بنا أن ندرس العلاقة بين التبرير والتقديس في العهد الجديد، ولا سيَّما في الرسالة إلى رومية، حيث تحظى الفكرتان بتناول تفصيليٍّ ومطوَّل للغاية.
كان التبرير هو موضوع رومية 1-5. شدَّد بولس في هذا الجزء على أنَّ لا أحد يمكن أن يتبرَّر في نظر الله بأعماله (1: 18-3: 20)، وأكَّد أنَّ هذا التبرير يأتي كعطيَّة مجَّانيَّة بالفداء الذي حقَّقه المسيح (3: 21-31). ثمَّ أثبت بولس من خلال مثال إبراهيم أنَّ التبرير يأتي فقط بالإيمان، وليس بالأعمال (الأصحاح 4). ثمَّ في الأصحاح الخامس، قال بولس: “فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِٱلْإِيمَانِ لَنَا سَلَامٌ مَعَ ٱللهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، ٱلَّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا ٱلدُّخُولُ بِٱلْإِيمَانِ، إِلَى هَذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي نَحْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ، وَنَفْتَخِرُ عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ ٱللهِ” (الآيتان 1-2). فالتبرير ليس شيئًا لا يزال المؤمنون في طور الحصول عليه، لكنَّه حقيقة تمَّت بالفعل في حياة الذين يؤمنون بالمسيح. وقال بولس إنَّ السلام مع الله (أي انتهاء العداوة بين البشر والله، تلك العداوة التي سبَّبتها الخطيَّة) هو في حيازة المؤمنين حاليًّا، وليس شيئًا لا يزالون يطمحون إليه.
ثمَّ أوضح بولس مكانة المؤمن في نظر الله بمزيد من التفصيل في الآيات 9-11:
فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرِّرُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ ٱلْغَضَبِ! لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ ٱللهِ بِمَوْتِ ٱبْنِهِ، فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ! وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِٱللهِ، بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْآنَ ٱلْمُصَالَحَةَ.
هذه التصريحات تبيِّن أنَّ التبرير ليس مجرَّد معاملة قضائيَّة، وليس مجرَّد “احتكام إلى عدالة غير حقيقيَّة”، كما اتَّهمه فلوروفسكي، لكنَّه أيضًا أمر شخصيٌّ. فقد كنَّا أعداءً لله، لكنَّنا صولِحنا معه. فنحن الذين نؤمن بالمسيح صرنا الآن أحبَّاء الله، وصارت علاقتنا به مضمونة بما يكفي لدرجة أنَّ بولس أمكنه أن يهتف في ثقة ويقين قائلًا إنَّنا سنخلص بالمسيح من الغضب. فالتبرير هو أن يُحكَم ببرِّ أحدهم، لكنَّه أيضًا يفوق ذلك. ففضلًا عن ذلك، هو قبول الله لدخول الخطاة في شركة معه، كما لو أنَّهم أبرارٌ بالفعل.
سبقت تصريحات بولس الواثقة عن هذا القبول (6: 1) طرحه للسؤال المتعلِّق بالكيفيَّة التي يجب على المؤمن أن يسلك بها نتيجةً لتبريره. وهذه التصريحات تأتي قبل، وليس بعد، حديثه عن صراعاته مع الخطيَّة، وعن الحلِّ لتلك الصراعات، الذي هو السلوك بالروح (الأصحاحان 7، 8). كما تأتي قبل الحديث الأخلاقيِّ المطوَّل الممتدِّ من الأصحاح 12 وحتَّى الأصحاح 15. فإنَّ هذه المقاطع اللاحقة من الرسالة تمثِّل شرح بولس لعمليَّة التقديس. ويلعب الجهد البشريُّ والأعمال دورًا مهمًّا في هذا الشرح. لكن تشبيه بولس للمؤمن بالعبد الذي يخدم سيِّدًا جديدًا، وبالزوجة التي تتزوَّج من زوج جديد (6: 19-7: 3)، يبيِّن أنَّه لأنَّ المؤمنين صاروا بالفعل مقبولين من الله، فيسعون إلى السلوك بحسب مشيئته. مثل هذه الأعمال ليست هي وسائل التبرير، لكنَّها نتائج نابعة من التبرير.
ومع أنَّ الرسالة إلى رومية تقدِّم التناول الأشدَّ تفصيلًا للفرق بين التبرير والتقديس. هذه الفكرة ليست قاصرة على كتابات بولس، فإنَّ تحريض بطرس على السلوك بالقداسة (1 بطرس 1: 13-25) يأتي بعد تسبيحه وحمده لله لأجل الولادة الجديدة لرجاء حيٍّ والميراث الذي لا يفنى المحفوظ في السماوات، الذي هو للمؤمنين بالفعل (1 بطرس 1: 3-12، وبالأخصِّ 3-5). كذلك، عبَّر يوحنَّا عن تعجُّبه من عظم المحبَّة التي أعطانا الله إيَّاها، حتَّى نُدعَى أولاد الله. وفقط بعد تأكيده أنَّ المؤمنين هم الآن أولاد الله، أمكنه أن يقول إنَّ الذين يتحلَّون بالرجاء في الله يسعون إلى أن يطهِّروا أنفسهم كما أنَّ الله هو طاهر (1 يوحنَّا 3: 1-3). وتبيِّن كلمات يسوع إلى اللصِّ التائب على الصليب أنَّ هذا اللصَّ قُبِل في الحال داخل محضر الله، مع أنَّه لم يعش ليخضع لأيِّ تقديس على الإطلاق (لوقا 23: 39-43).
في ضوء هذه التفرقة، يجب أن يتَّضح لنا أنَّ الفهم الأرثوذكسيَّ للخلاص يشدِّد فقط على جانب واحد (وإن كان جانبًا مهمًّا جدًّا) من الصورة الكتابيَّة، وهو عمليَّة التقديس. وفي حقيقة الأمر، ترد عبارة “شركاء الطبيعة الإلهيَّة” -التي تُعَدُّ حيويَّة للغاية للفهم الأرثوذكسيِّ للتألُّه- في مقطع يدور حول موضوع التقديس. كتب بطرس في 2 بطرس 1: 3 قائلًا إنَّ قدرة الله قد وهبت المؤمنين كلَّ ما نحتاج إليه للحياة والتقوى بمعرفتنا للمسيح. وفي الآية 4، ربط بطرس اشتراك المؤمنين في الطبيعة الإلهيَّة بالمواعيد العظمى والثمينة التي حصلنا عليها بالفعل. ثمَّ في الآيات 5-9، سرد بعض السمات التي على المؤمنين أن يسعوا للحصول عليها. ومن خلال هذا التسلسل في الأفكار، يتبيَّن لنا من خلال معرفة المؤمنين للمسيح، وامتلاكهم لمواعيده، أنَّهم متبرِّرون، وأنَّه بناءً على هذه الحقيقة، يهبنا الله كلَّ ما نحتاج إليه للتقديس (الحياة والتقوى)، حتَّى نتمكَّن من الاشتراك في الطبيعة الإلهيَّة، واكتساب السمات التي ذكرها بطرس.
وإنَّ إخفاق الأرثوذكسيَّة في التمييز على نحو كافٍ بين التبرير والتقديس، ونقص تركيزها على التبرير، إنَّما هو متَّصل بمفهومها عن النعمة. لاحظنا قبلًا أنَّ المسيحيَّة الشرقيَّة تنظر إلى النعمة على أنَّها طاقات منبعثة من الله، تُنقَل إلى البشر، فتؤلِّههم. هذه الفكرة تعكس بدقَّة جزءًا من تعليم بولس عن النعمة. فإنَّ “مواهب النعمة” (الكلمة اليونانيَّة المترجمة إلى “مواهب” مشتقَّة من الجذر نفسه للكلمة التي تُترجَم إلى “نعمة”) التي كتب بولس عنها في 1 كورنثوس 12، هي فعليًّا “إمكانيَّات أو قدرات النعمة”، أي الإمكانيَّات النابعة من الروح القدس الساكن في المؤمن. وفي 1 كورنثوس 15: 10، نسب بولس إنجازاته الرسوليَّة إلى “نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلَّتِي مَعِي”، الأمر الذي ربَّما يشير إلى أنَّ نعمة الله هي قوَّة روحيَّة تعمل من خلاله. وفي 2 كورنثوس 12: 9، كان جواب الله عن التماس بولس بشأن رفع الشوكة التي في جسده: “تَكْفِيكَ نِعْمَتِي، لِأَنَّ قُوَّتِي فِي ٱلضَّعْفِ تُكْمَلُ”. تبيِّن هذه النصوص أنَّ النعمة هي، من ناحيةٍ ما، قوَّة أو طاقة يعطيها الله للمؤمن.
ومع ذلك، ليس هذا هو المعنى الوحيد لكلمة “نعمة” في كتابات بولس. بل بالأحرى، كلمة “النعمة” مستخدمة في المقام الأوَّل للتعبير عن عطيَّة الخلاص. يعطي الله الخلاص مجَّانًا للخطاة الذين ليس بمقدورهم فعل شيء لاستحقاقه. وتشير “النعمة” إلى الطبيعة غير المستحَقَّة لعمل الله. وربَّما يبدو هذا الاستخدام لكلمة “نعمة” أشدَّ وضوحًا في أفسس 2: 1-10، حيث أكَّد بولس مرَّتين قائلًا: “بِٱلنِّعْمَةِ أَنْتُمْ مُخَلَّصُونَ” (الآيتان 5، 8). وزمن الماضي التام للفعل في هاتين الآيتين يبيِّن أنَّ خلاص القرَّاء كان قد تحقَّق بالفعل (التبرير)، وكذلك أنَّ نتائجه (أي السلوك المسيحيّ والتقديس) لا تزال مستمرَّة. ويركِّز السياق ككلٍّ على عدم استحقاق المؤمنين للخلاص، وعجزهم عن أن يخلِّصوا أنفسهم: فقد كنَّا أمواتًا، لكن الله أحيانا (الآيتان 1، 5). والخلاص ليس منَّا (الآية 8). ومن ثَمَّ، فإنَّ القول بأنَّنا خلصنا بالنعمة معناه أنَّ الله قَبَلنا وأحيانا مع أنَّنا لم نكن نستحقُّ هذه العطيَّة، ولم يكن بوسعنا فعل شيء من أنفسنا للحصول عليها. هذا أيضًا هو المعنى الذي استخدم به بولس كلمة “النعمة” في رومية 5: 2، وأفسس 1: 5-6، وتيطس 2: 11، وفي نصوص أخرى تدور حول الخلاص.
هذا الافتقار في اللاهوت الأرثوذكسيِّ إلى التركيز على هذا الجانب من النعمة يُسهِم في الإخفاق الشرقيِّ في التشديد على طبيعة الخلاص بصفته عطيَّة مجَّانيَّة. يؤدِّي ذلك بدوره إلى إخفاق في التمييز بين التبرير باعتباره قبولًا مجَّانيًّا لخطاة غير مستحقِّين في بداية الإيمان، والتقديس باعتباره العمليَّة التي بها يصيرون أبرارًا، والتي تنطوي على بذل جهدٍ بشريٍّ. وفي حين أنَّ التركيز على عمليَّة التألُّه نفسه هو تركيز لائقٌ في حدِّ ذاته، لكن الافتقار إلى التشديد على الحدث الذي يبتدئ تلك العمليَّة يسفر عن نظرة مشوَّهة إلى حدٍّ كبير عن الحياة المسيحيَّة.
بعض التعليقات الختاميَّة
هذه المقالة سلَّطت الضوء على جوانب متعدِّدة من أوجه الخلاف في الرأي بين الإنجيليِّين والأرثوذكسيِّين. وفي حقيقة الأمر، ربَّما يتساءل بعض القرَّاء عن سبب تركي لبعض المفاهيم الشرقيَّة (مثل المفهوم القائل بأنَّ الله يكون بلا قوَّة أمام حريَّة الإنسان، أو أنَّ الأسرار تعطي نعمة) تمضي دون التعليق عليها. لكنَّني حاولتُ أن أبيِّن أنَّ لُبَّ خلافنا الإنجيليِّ مع الأرثوذكسيَّة لا يكمن في تلك الجوانب. بل في واقع الأمر، هذه قضايا يوجد خلاف في الرأي عليها حتَّى بداخل الإنجيليَّة الغربيَّة نفسها، وليس فقط في ما بين الغربيِّين والشرقيِّين. لكنَّني أعتقد أنَّ الاختلاف الرئيسيَّ بين الأرثوذكسيَّة الشرقيَّة وكلِّ أشكال الإنجيليَّة تقريبًا يكمن في العلاقة بين التبرير والتقديس، وفي عدم تركيز الأرثوذكسيَّة على الفرق بين الاثنين.
قطعًا، غالبيَّة الأرثوذكسيِّين، ولا سيَّما الأوروبيِّين الشرقيِّين الذين تُعَدُّ الأرثوذكسيَّة جزءًا من ثقافتهم لكنَّهم ربَّما ليسوا متداخلين في الكنيسة سوى بشكل هامشيٍّ، ليس لديهم فهم واضح للعقيدة الشرقيَّة عن الخلاص. (على سبيل المثال، ظللتُ مقيمًا في الاتِّحاد السوفيتِّي السابق لعدَّة سنوات دون أن أسمع شخصًا أرثوذكسيًّا واحدًا يستخدم مصطلح “التألُّه”). ومع ذلك، فالعقيدة الأرثوذكسيَّة تؤثِّر في البشر على الأرجح عن طريق إثارة شعور في داخلهم بأنَّهم بحاجة إلى تكميل أنفسهم حتَّى يتسنَّى لهم التمتُّع بشركة كاملة مع الله. ربَّما تتَّخذ هذه الفكرة لدى كثيرين، ممَّن ليسوا على ارتباط قويٍّ بالأرثوذكسيَّة، شكلًا لا يتعدَّى شعورًا بأنَّ التناول من الإفخارستيا، وممارسة الأعمال الصالحة، هي أمور مرغوب فيها. أمَّا آخرون (ولا سيَّما من غير المؤمنين، لكن ممَّن لديهم جوع روحيّ شديد) يمكن للتركيز على الخلاص باعتباره تألُّهًا أن يؤدِّي إلى قدر كبير من الشعور بالذنب والإحباط، بسبب ما يجدونه في أنفسهم من عجز عن أن يكمِّلوا أنفسهم بما يكفي للتمتُّع بالاتِّحاد بالله والشركة معه (أعرف كثيرين ممَّن يعانون بالفعل من ذلك).
من الواضح أنَّ مثل هؤلاء لا يَلزَمهم في المقام الأوَّل أن يسمعوا بأنَّ الأسرار لا تعطي التألُّه، أو بأنَّ الجهد البشريَّ ليس كافيًا لنوال الخلاص؛ لكنَّهم يحتاجون أوَّلًا إلى أن يسمعوا رسالة التبرير. فالاتِّحاد بالله ليس هو الوصف الكامل في الكتاب المقدَّس للخلاص. فإنَّ جزءًا أساسيًّا من الخلاص (وهو على الأرجح جزء غير مألوف لدى غالبيَّة الأوروبيِّين الشرقيِّين، أو حتَّى لدى الغربيِّين من خلفيَّات أرثوذكسيَّة) هو استعداد الله أن يمنح التبرير للبشر كعطيَّة مجَّانيَّة. عندما نوضِّح هذه الفكرة، يلزم أن نحرص جيِّدًا على أن لا نعبِّر عنها ببساطة على أنَّها تغيير يحدث في المقام القضائيِّ للخاطئ في نظر الله، أي على أنَّها تقتصر على الحكم على أحدهم بأنَّه “غير مذنب”، بدلًا من أن يكون “مذنبًا”. مثل هذه المصطلحات هي قطعًا دقيقة، لكنَّها لا تعبِّر عن كلِّ ما يعنيه الكتاب المقدَّس عن التبرير. ومن الصعب على شخص شرقيٍّ، ليس لديه فكر قضائيٌّ أن يستوعبه. وفي المقابل، نحن نفعل حسنًا إن شدَّدنا على الجانب الشخصيِّ من التبرير، أي على أنَّه قبول الله لدخول الخطاة في شركة معه، حتَّى وهم غير كاملين. فلا داعي أن يتحقَّق مثل هذا القبول بعد اكتمال عمليَّة طويلة من التألُّه؛ لكن في المقابل، الله بواسطة ابنه يسوع المسيح، قد تمَّم وحقَّق بالفعل كلَّ ما يطالب به البشر حتَّى يقبلهم. ويظلُّ على الشخص فقط أن يقبل هذه العطيَّة المتمثِّلة في قبول الله له بالإيمان بالمسيح، حتَّى يبدأ في اختبار فرح الشركة معه. وهذه الشركة، التي تبدأ ببداية الإيمان، ليست هي نتيجة اكتمال عمليَّة مشابهتنا لصورة المسيح، لكنَّها تشكِّل الأساس لاتِّباع حياة تشبه المسيح.