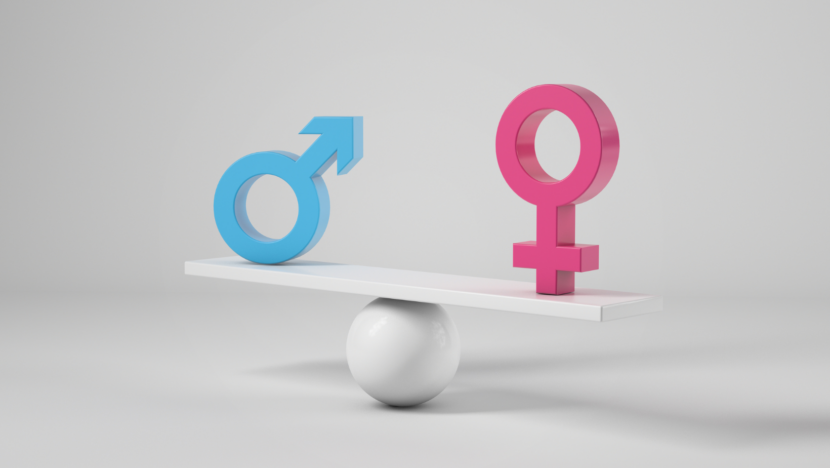التعريف
التوجه الجنسي هو قدرة أو ميل مستمر، دون اختيار، إلى الرغبات الجنسيَّة تجاه أحد أو كلا الجنسين. وإعادة التعريف الحديثة لنوع الجنس هي أنه تصوُّر الإنسان عن نفسه بأنه ذكر أو أنثى.
الموجز
عند الحديث عن السلوك الجنسي والرغبات الجنسيَّة تجاه الجنس نفسه، يَدّعيّ البعض أن الكتاب المقدَّس ليس لديه ما يقوله عن التوجه الجنسي. لكن استخدام بولس لكلمة “ساركس” (“الجسد” أو “الطبيعة الخاطئة”) يمكن أن يفيدنا في فهم أولئك الذين لديهم ميول مستمرة لم يختاروها، وفي تقديم خدمة أفضل لهم. فالأمر الذي يكمن في جذور الخلط الحادث اليوم بشأن الذكر والأنثى هو الإعلاء من شأن الاختبار الشخصي على الحق الموضوعي المطلق. بتعبير آخر، إن تصور الإنسان عن نفسه صار يطغي على الحالة البيولوجية. لكن الذين يصارعون مع عدم تقبل لنوع جنسهم يجب ألا يوصَموا دون وجه حق. فإنهم يصارعون مع عواقب السقوط، كما هو حال جميع البشر. والحل يبدأ وينتهي بالإيمان بالمسيح.
فهم التوجه الجنسي
ينبع مفهوم التوجه الجنسي من مجالي علم النفس والطب النفسي العلمانيين. فللأسف، يقحم المؤمنون أنفسهم في نظريات العلوم الاجتماعية هذه، بدلًا من أن يبنوا فهمهم الحيوي للتوجه الجنسي على التعليم الكتابي واللاهوتي.
فإن مؤيدي المثلية، بل وبعض المؤمنين أيضًا، يؤكدون أن الكتاب المقدَّس ليس لديه ما يقوله عن “التوجه الجنسي”، وبالتالي فإما أنه لا يدين العلاقات المثلية، وإما لم يكن واضحًا بشأن إدانتها.[1] وهو يقولون إنه في النهاية، هذا المصطلح لا يظهر في أي موضع على صفحات الكتاب المقدَّس. لكن هذا الفهم الساذج لكيفية صياغة اللاهوت النظامي –أي بأن غياب كلمة معينة مكافئ للصمت– يعني إذن أنه ليس لدى الكتاب المقدَّس ما يقوله عن العديد من العقائد الجوهرية، وأهمها عقيدة الثالوث. إلا أن الكتاب المقدَّس يرسم صورة لاهوتية تشمل كلَّ مجالات الحياة.
فحتى إذا لم تكن عبارة “التوجه الجنسي” موجودة في الكتاب المقدَّس، هل يتناول الكتاب المقدَّس موضوعًا شبيهًا بذلك؟ يجب أن نبدأ هنا إذن بتعريف للعبارة. تصف المنظمة الأمريكية لعلم النفس هذه العبارة كالتالي: “يشير التوجه الجنسي إلى نمط مستمر من الانجذاب العاطفي، أو الرومانسي، أو الجنسي إلى الرجال، أو النساء، أو إلى كلا الجنسين”.[2] وهذه المنظمة تقول أيضًا إن هذا الانجذاب في العموم لا يكون عن اختيار.[3]
في عام 2006، أصدر ناشطو حقوق الإنسان الدوليون مبادئ يوجياكارتا، معرِّفين التوجه الجنسي بأنه “قدرة على الانجذاب العاطفي، والرومانسي، والجنسي الشديد”.[4] وفي كتاب سايمون لوفاي (Simon LeVay)، عالم الأعصاب المثلي، بعنوان “مثلي أم مستقيم، والسبب: علم التوجه الجنسي“، عرَّف التوجه الجنسي بأنه “السمة التي تجعلنا نميل إلى اختبار الانجذاب الجنسي”.[5] وبجمع هذه التعريفات معًا، نرى إذن أن التوجه الجنسي يُفهَم على أنه قدرة أو ميل مستمر، دون اختيار، إلى الرغبات الجنسيَّة تجاه أحد الجنسين أو كليهما.
تعريف الرغبات الجنسيَّة المستمرة دون اختيار: الجسد
قبل أن نرى ما إذا كان الكتاب المقدَّس يتحدث عن أية ميول مستمرة دون اختيار، يجب أولًا أن نفصل أنفسنا عن النموذج العلماني الذي يتحدث عن الرغبات تجاه الجنس الآخر، وعن الرغبات الجنسيَّة تجاه الجنس نفسه، ونستخدم في المقابل الألفاظ الكتابيَّة التي تفصل بين الرغبات الجنسيَّة الصالحة، والرغبات الجنسيَّة الشريرة. فإن الرغبات الجنسيَّة والرومانسيَّة الصالحة هي التي تقع داخل إطار الزواج الكتابي، والرغبات الجنسيَّة والرومانسيَّة الشريرة هي الخارجة عن إطار الزواج الكتابي.
وبما أن كل الرغبات الجنسيَّة والرومانسيَّة تجاه الجنس نفسه هي رغبات خاطئة وشريرة، فهل يوجد إذن أي مفهوم كتابي يصف قدرة أو ميلًا مستمرًّا، دون اختيار، إلى الرغبات الشريرة؟ وهل يقدم الكتاب المقدَّس إطارًا لاهوتيًّا واضحًا لفك تعقيد الكلام الصعب والمحير عن التوجه الجنسي؟ أجل، يدعو الكتاب المقدَّس هذا الميل باسم الجسد (“ساركس”) أو الطبيعة الخاطئة. وبمعنى آخر، يصفه بأنه توجه خاطئ. وهذا يندرج في عقيدة الخطية (“هامارتيولوجيا”).
بعض ترجمات العهد الجديد تترجم الكلمة اليونانية “ساركس” إلى “طبيعة خاطئة”، في حين يترجمها البعض الآخر حرفيًّا إلى “الجسد”. وكلمة “ساركس” هي مفهوم مهم، ولا سيما في فكر بولس اللاهوتي. أوضح دوجلاس موو (Douglas Moo)، الخبير في كتابات بولس، أنه في كتابات بولس بصفة خاصة (كما في الرسالة إلى رومية والرسالة إلى غلاطية)، كلمة “ساركس” تشير إلى “محدوديات الحالة البشرية، التي فرضتها الخطية”.[6]
في غلاطية 5: 16-17، أوضح بولس كيف يقاوم الجسد الروح، وتقاوم الروح الجسد. وهذا الصراع الثنائي لا يوحي بأن لنا طبيعتين منقسمتين في داخلنا، تحارب إحداهما الأخرى، بل تشير كلمة “ساركس” إلى الشخص ككل، الذي يتسم بالتمرد – أي “الفساد والفناء” – الذي يتسم به العالم الحاضر الشرير.[7]
يعكس ذلك الحقيقة الخلاصية القديمة عن الإنسان العتيق، الذي يوصف بالجسد، والإنسان الجديد، الذي يميزه الروح القدس. وهذا الصراع بين الجسد والروح هو برهان على التداخل الموجود بين هذا الدهر الشرير والدهر الآتي. فالجسد يمثل هذه الحقبة الشريرة، وخضوعنا تحت سيادة الجسد والموت. والروح يمثل الدهر الآتي، وتحررنا من سطوة الخطية والناموس.[8] وفي هذا التداخل، تتواجد جوانب من كلا الدهرين معًا.
والحقيقة هي أن “العالم الحاضر الشرير” (غلاطية 1: 4) لم يمض، وتأثيرات الخطية و”الإنسان العتيق” لا تزال موجودة. وكمؤمنين نالوا الفداء، نحن نتجدد ونتغير يومًا فيوم، إلا أننا لا زلنا نعيش مع بقايا إنساننا العتيق، ومع صورة ما بعد السقوط المشوَّهة. ولذلك، يجب أن نكون صاحين ويقظين في وسط التجارب. عبَّر ديني بورك (Denny Burk) وهيث لامبرت (Heath Lambert) عن هذا الأمر جيدًا قائلين إن لدينا، بخلاف يسوع، الذي لم تكن لديه طبيعة خاطئة، “مهبط طائرات” لتلك التجارب التي يمكن بسهولة أن تتحول إلى شهوة شريرة.[9]
محاربة الجسد
توجد معركة روحية دائرة “بين روح الله والحافز على ارتكاب الخطية”.[10] وهذا الحافز لم يعد يستعبد المؤمن، لكن لا يزال ممكنًا أن يؤثر فيه؛ ولهذا نواجه صراعًا يوميًّا. في رومية 8: 13، يناشدنا بولس قائلًا: “لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَتَحْيَوْنَ”.
إن خلاص المسيح افتتح بالتأكيد حقبة جديدة، لكن هذه الحقبة الجديدة لم تكتمل بالكامل، وهذا ما يعبِّر عنه مبدأ “الآن وليس بعد”. فقد تحرَّرنا، لكن يجب أن نستمر في المثابرة في المعركة حتى يأتي ذلك اليوم المجيد والأخير. وما الذي يعنيه ذلك للذين لديهم ميل إلى التجارب الجنسيَّة والرومانسية تجاه الجنس نفسه، لكنهم يميتونها كلَّ يوم؟
يجب أن ندرك جيدًا أن الميل ليس مكافئًا لاتخاذ القرار. في رومية 6: 6-7، كتب بولس يقول إن الإنسان، بفضل اتحاده بالمسيح، يتحرر من عبودية الخطية والطبيعة البشرية الساقطة: “عَالِمِينَ هَذَا: أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلَ جَسَدُ ٱلْخَطِيَّةِ، كَيْ لَا نَعُودَ نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ. لِأَنَّ ٱلَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرَّأَ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ”.
هذه الحرية من مُلك وسيادة الخطية لا تعني حرية من أي ارتكابٍ للخطية، أو غيابًا كاملًا للتجارب، لكنها تعني انفصالًا حاسمًا عن الخطية، وتغييرًا كيفيًّا، به يصير ذهننا أقل ظلمة، وتصير إرادتنا أقل تمردًا. وهذه الحياة الجديدة هي عمل الله السيادي.
وإن الروح القدس هو المسبِّب الإلهي لميلادنا الثاني (يوحنا 3: 5-6)، وهذه الحرية من الخطية هي عمل نعمة الله: “فَإِنَّ ٱلْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ، لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ ٱلنِّعْمَةِ” (رومية 6: 14). أوضح جون بايبر (John Piper) هذا قائلًا: “النعمة ليست مجرد تساهل وتسامح معنا عندما نخطئ، لكنها عطية الله التي تمكننا من ألا نخطئ. فالنعمة قوة، وليس مجرد صفح”.[11]
الأمر الآخر الذي يجب أن نتذكَّره هو تجنُّب التطرُّف. فعلى أحد طرفي النقيض، يجب ألا نستهين بنعمة الله، ونفترض قدرتنا على مواصلة ارتكاب الخطية لأن “ٱلْمَحَبَّةَ تَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا” (1بطرس 4: 8). سيكون هذا تحريفًا، تحدث عنه بولس بصورة مباشرة قائلًا: “فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَنَبْقَى فِي ٱلْخَطِيَّةِ لِكَيْ تَكْثُرَ ٱلنِّعْمَةُ؟ حَاشَا! نَحْنُ ٱلَّذِينَ مُتْنَا عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ، كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا؟” (رومية 6: 1-2).
لكن على طرف النقيض الآخر، بعض الذين يعانون من غواية جنسية تجاه الجنس نفسه مثقَّلون بشكل زائد عن الحد بالخزي والشعور بالذنب، لأنهم يشعرون بأنهم لا يستحقون نعمة الله. فقد تابوا، وهم لا يمارسون هذه الخطية، لكنهم يظنون أن هذا الصراع الذي يعانون منه هو الخطية التي ليس لها غفران. لكن عند إدراكنا أن المشكلة تكمن في جسدنا – أي في طبيعتنا البشرية الساقطة – نستطيع أن ندرك كل يوم أننا لسنا مختلفين كثيرًا عن أي شخص آخر.
يعود كل شيء في الأصل إلى الخطية الأصلية. فإن العاقبة الأدبية للسقوط قد أفسدت كل إنسان. قد يختلف الشكل المحدد للتجربة، لكن السبب الأصلي لا يزال واحدًا. والقضية ليست إن كنا نجرب أم لا، بل كيف نتجاوب مع التجربة.
وتأتي التعزية من معرفتنا أننا لسنا بمفردنا. فينبغي أن نتحلَّى بالصدق والوضوح في الحديث مع أناس نثق بهم عن صراعاتنا مع تجارب مستمرة لم نخترها. لكن تقسيم أنفسنا إلى “مؤمنين مستقيمين” و”مؤمنين مثليين” يخلف الانطباع الخاطئ بأننا في جوهر كياننا مختلفون عن بعضنا البعض.
لكن في المقابل، يجب أن نجد الوحدة التي تجمع بيننا في حقيقة أننا نعاني جميعًا من الخطية الأصلية، أي من النتيجة الأدبية للسقوط، وأننا جميعًا بحاجة إلى النعمة. ويجب أن نذكر بعضنا البعض معًا بحاجتنا الماسة إلى الحل الوحيد لطبيعتنا الخاطئة، وهو المسيح وجسده، الذي هو الكنيسة.
ذكر وأنثى: الهوية الجنسيَّة
هل “نوع الجنس” هو تصنيف اجتماعي؟ وهل يوجد أكثر من نوعي جنس؟ مع أن الغرب الحديث تخطَّى الحدود، وصار يفتخر بمجموعة كبيرة مما يسمِّيه خيارات في نوع الجنس، كيف يجب على المؤمنين أن يفهموا إعادة التعريف في يومنا هذا لنوع الجنس في ضوء الكتاب المقدَّس، وأن يتمكنوا من نقدها جيدًا؟
كلمة “جنس” [sex] لها تعريفان. فهي تشير في المعتاد إلى ممارسة الجنس، لكن يمكن أن تشير أيضًا إلى التصنيف إلى ذكر وأنثى. وفي هذه الدراسة، سنركز على التعريف الثاني. وتصنيف الجنس إلى ذكر وأنثى هو تصنيف ثنائي مطلق وموضوعي، يصف التصنيف التناسلي للجسم.
لكن الكثيرون اليوم يدعون أن الجنس ليس أمرًا مطلقًا موضوعيًّا، بل أمرًا اعتباطيًّا، مؤكدين على سبيل المثال إن الجنس يُعطَى للشخص عند ميلاده. لكن ليس هذا الأمر اعتباطيًّا، لأن جنس المولود يلاحَظ بصورة مادية ملموسة من خلال الأعضاء التناسلية المنظورة للطفل، ويمكن تأكيده جينيًّا من خلال تحليل الحمض النووي. فإن للجنس سمات مظهرية صريحة وواضحة، وقول غير ذلك هو أمر غير علمي تمامًا، وسيعني أننا يجب أن نعيد كتابة كل مرجع من مراجع علم الأحياء كُتِب على الإطلاق.
لكن ماذا عن الأشخاص “ثنائيي الجنس”؟ هل هذه الحالة النادرة والاستثنائية تثبت أن الجنس ليس نوعين، لكنه قائمة طويلة؟ كلا، فإن ثنائية الجنس هي ظاهرة بيولوجية فيها قد يعاني الشخص من التباس تناسلي، أو تنوع جيني. لكن في علم الأحياء البشري، التشوهات لا تلغي هذا التصنيف الثنائي للجنس.
لكن “نوع الجنس” أعيد تعريفه في العصر الحديث، ليكون واقعًا نفسيًّا مستقلًّا عن الجنس البيولوجي. فنوع الجنس، وفقًا لذلك، هو تصور الشخص عن نفسه بأنه ذكر أو أنثى. لكن في ضوء أن الجنس حقيقة مطلقة موضوعية، في حين أن نوع الجنس، وفقًا لإعادة التعريف الحديثة له، هو حقيقة شخصية خاصة، ربما سنتوقع أن يكون التصرف السليم هو توفيق أفكارنا الشخصية مع الحق المطلق الموضوعي. لكن العكس هو الذي يحدث، حيث يغيِّر المجتمع الحديث الحقيقة المطلقة والجسدية لأجسادنا كي تتوافق مع تصورنا الشخصي عن أنفسنا.
وهذا الشكل الجديد من الثنائية الغنوسية يفصل الذهن عن الجسد، ويعلي من شأن تصور الإنسان عن نفسه على أنه هو ما يحدد شخصيته؛ ومن هنا نبع المصطلح الجديد “الهوية الجنسيَّة”. وحقيقة الأمر هي أن وعي الشخص بنفسه يصف على أقصى تقدير ما نشعر به، وليس من نحن عليه بالفعل.
الكتاب المقدَّس والهوية الجنسيَّة
في الأصحاح الأول من الكتاب المقدَّس، خلق الله السماوات والأرض، وملأ الأرض بالكائنات الحية. وكان تاج الخليقة هو آدم، أو الإنسان (الجنس البشري). ومن بين كل سمات الإنسان المختلفة، سلط الله الضوء على سمة واحدة بصفة خاصة، وهي أنه ذكر وأنثى.
يُظهِر تكوين 1: 27 وجود صلة لا يمكن إنكارها بين “صورة الله”، والتصنيفين الوجوديين للإنسان إلى ذكر وأنثى. تتألف هذه الآية من ثلاثة أشطر شعرية، حيث كان الشطر الثاني والثالث متوازيين، وهو ما يعبر عن وجود رابط بين صورة الله، وبين “الذكر والأنثى”.
فَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ.
عَلَى صُورَةِ ٱللهِ خَلَقَهُ.
ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ.
فإن خلق الإنسان على صورة الله، وكونه ذكرًا وأنثى، هما أمران لا غنى عنهما في الطبيعة البشرية. فإن الجنس (ذكر وأنثى) ليس مجرد أمر بيولوجي أو جيني، تمامًا كما أن بشرية الإنسان ليست مجرد سمة بيولوجية أو جينية. فالجنس هو في المقام الأول حقيقة روحية ووجودية خلقها الله. ولا يمكن لأيدٍ بشرية أن تغير كون أحدهم ذكرًا أو أنثى. فالجنس هو عمل يدي الله، أي تصميمه وقصده وتعيينه الأصلي.
من الصعب للغاية أن يحاول أحدٌ تغيير هذه الحقيقة في جسده، وبالتالي، فإن أقصى ما يمكن فعله هو إزالة بعض أعضاء الجسد جراحيًّا، أو محاولة تضخيم حجمها، أو استخدام الأدوية لقمع الحقيقة البيولوجية والهرمونية لجنس الإنسان بطريقة غير طبيعية. بتعبير آخر، صار علم النفس اليوم هو الذي يتغلب على علم الأحياء، وصار ما أشعر به هو ما أنا عليه. وعندما نرفض هذه الحقيقة الجسدية والجينية، نسمح للاختبار الشخصي بأن يتفوق على الجوهر، والأهم من ذلك، أننا نسمح له بأن يتفوق ويعلو على صورة الله. وبالتالي، فإن التحول الجنسي ليس في المقام الأول صراعًا جنسيًّا جسديًّا، لكنه بالأحرى صراع للتحول إلى الحقيقة التي يتصورها الشخص عن نفسه.
كيف إذن وصلنا إلى هذا الحد؟ التحول الجنسي هو نتاج فكر ما بعد الحداثة. وإن فكر ما بعد الحداثة، النابع من الرومانتيكية والوجودية، يقول لنا “أنت ما تشعر به”. وبالتالي، فإن الاختبار الشخصي صار هو الملك الذي يسمو فوق كل شيء، وكل شيء آخر يجب أن ينحني أمامه. فإن سولا إكسبيريينشيا (“الاختبار وحده”) قد انتصرت على سولا سكريبتورا (“الكتاب المقدَّس وحده”).
لكن الله يقول لك: “أنت من خلقتك لتكون عليه”. فالحق ليس شيئًا نشعر به، وليس شيئًا مبنيًّا على تصورنا عن أنفسنا. بل في حقيقة الأمر، يخبرنا الكتاب المقدَّس بأن القلب الساقط “أَخْدَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ نَجِيسٌ، مَنْ يَعْرِفُهُ؟” (إرميا 17: 9). فإننا لا نقدر أن نثق في أفكارنا ومشاعرنا الشخصية، ولذلك يَلزَم أن نخضعها لله، لأننا نستطيع أن نتوكل “عَلَى ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلْأَبَدِ، لِأَنَّ فِي يَاهَ ٱلرَّبِّ صَخْرَ ٱلدُّهُورِ” (إشعياء 26: 4).
إن تصور غالبية البشر عن أنفسهم مطابق لجنسهم البيولوجي، لكن هذا ليس الحال لدى نسبة مئوية صغيرة من البشر. والضيق والانزعاج العقلي الناتج عن عدم التناغم هذا يسمى بالخلل في تقبل نوع الجنس. ويختار بعض هؤلاء تعريف أنفسهم بأنهم متحوِّلون جنسيًّا من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر، معلين بهذا في الأساس من علم النفس على علم الأحياء.
مع أن تعريف النفس هو قرار شخصي، وخوض “علاج هرموني” أو عملية جراحية هو أيضًا قرار شخصي، لكن الصراع ليس كذلك. وبالنسبة للبعض، هذا الصراع حقيقيٌّ للغاية. لكن بقدر كون هذا غريبًا وغير معتاد، يجب أن ندرك أن وجود أفكار مستمرة لدينا متعارضة مع جنسنا الفعلي، وهي أفكار لم نخترها، هو نتيجة نفسية للسقوط. وجميع المؤمنين يشتركون معًا في اختبار الإماتة اليومية لنتائج السقوط.
وعند وضع التنافر بين نوع الجنس والجنس داخل أحدهم داخل إطار السقوط البشري، لن يبدو غريبًا كما يظن الكثيرون. فكما أن الاستسلام للتجربة هو خطية، في حين أن التعرض للتجربة ليس كذلك، هكذا الاستسلام لتصور ساقط عن النقس بشأن نوع الجنس هو خطية، في حين أن الصراع والحرب ليسا كذلك.
هل يجب أن يفاجئنا أن يهمس المضل في آذان البعض بشأن جنسهم قائلًا: “أحقًا قال الله؟”؟ دعونا إذن نلتزم بأن نصلِّي لأجل الذين يعانون من خلل في تقبل نوع جنسهم، لكي يتبعوا المسيح وحقه، بدلًا من أن يتبعوا أذهانهم المظلمة، ومخططات العالم بشأن العدالة الاجتماعية والسياسات المتعلقة بالهوية.
في كنائسنا، يوجد من يخشون الاعتراف بوجود هذا الخبل، وطلب الصلاة، لئلا يُرفَضوا ويتعرضوا للاستهزاء والسخرية. دعونا إذن نساند إخوتنا وأخواتنا الذين لا يشاكلون هذا الدهر، بل يتغيَّرون عن شكلهم بتجديد أذهانهم، مقاومين الأفكار الساقطة بشأن الخلل في تقبل نوع الجنس، ومستأسرين كل فكر فيهم إلى طاعة المسيح.
دعونا نتحد معًا في صراعنا ضد إعلاء علم النفس على علم الأحياء. ودعونا نُخضِع الكل لله، وندرك أنه لا يتركب أية أخطاء، وأنه خلقنا على صورته.
[1] James V. Brownson, Bible, Gender, Sexuality: Reframing the Church’s Debate on Same-Sex Relationships (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), 170; Matthew Vines, God and the Gay Christian: The Biblical Case in Support of Same-Sex Relationships (New York: Convergent Books, 2014), 106.
[2] American Psychological Association, Answers to Your Questions: For a Better Understanding of Sexual Orientation and Homosexuality (Washington, DC: APA, 2008), 1.
[3] American Psychological Association, Answers to Your Questions, 2.
[4] “The Yogyakarta Principles: Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity,” March 2007, 6, PDF.
[5] Simon LeVay, Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2017), 1.
[6] Douglas J. Moo, Galatians (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 344.
[7] N. T. Wright, Paul for Everyone: Romans, Part 1 (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 140.
[8] Thomas R. Schreiner, Paul, Apostle of God’s Glory in Christ: A Pauline Theology (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2001), 143.
[9] Denny Burk and Heath Lambert, Transforming Homosexuality: What the Bible Says About Sexual Orientation and Change (Phillipsburg, NJ: P&R, 2015), 50.
[10] Moo, Galatians, 354.
[11] John Piper, The Pleasures of God: Meditations on God’s Delight in Being God, rev. ed. (Colorado Springs: Multnomah, 2000), 244.