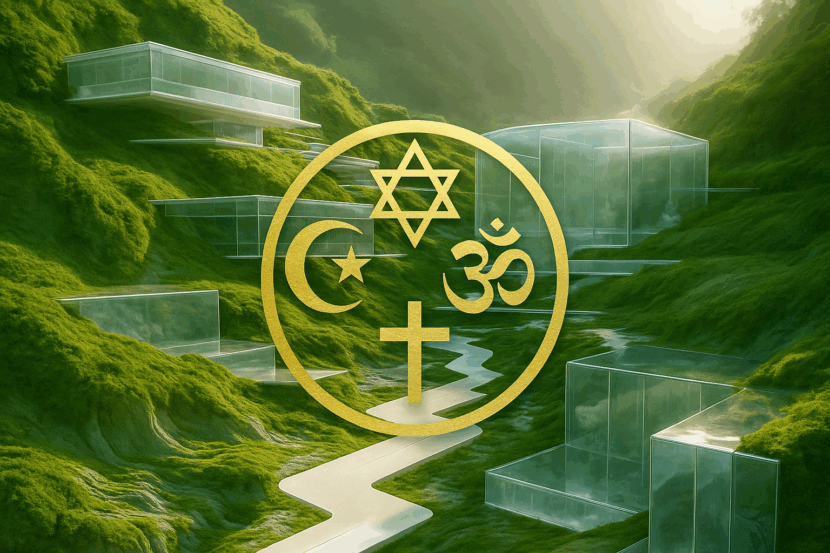في عالم يزداد فيه الصراع بين الأديان والمذاهب، وتنتشر فيه الفلسفات التي تدعو إلى توحيد الأديان أو إضعافها باسم “التسامح” و”السلام”، يطرح سؤال جوهري: هل جميع الأديان تقود إلى الله؟ وهل يمكن أن يسود وئام ديني حقيقي دون التمسك بالحق المطلق؟
في هذا المقال نتأمل في رسالة يوحنا الأولى (٤: ١-١٠)، حيث يكشف لنا الرسول يوحنا عن حرب روحية خفية تدور حول العقيدة، محذرًا من “أرواح الضلال” التي تختبئ خلف الأفكار والمذاهب المضللة. كما يبين أن المحبة الحقيقية لا تنفصل عن الحق، وأن الإيمان المسيحي ليس مجرد رأيًا شخصيًا، بل هو انتماء لله وحده في مواجهة عالم يسعى إلى طمس الفوارق العقائدية.
فهل نحن واعون لهذه المعركة الروحية؟ وهل نستطيع أن نميز بين روح الحق وروح الضلال؟ إن فهمنا لهذه الرسالة يساعدنا على إدراك لماذا لا يمكن المساومة على العقيدة، ولماذا تكون المحبة بلا حق مجرد محبة زائفة.
الصراع الديني عبر التاريخ
عندما تخطط أي شركة أو مؤسسة لتحقيق الربح، فإنها تسعى إلى التميز. وأكثر ما يميز أي مؤسسة هو إنتاج منتج بمواصفات فريدة وطرحه حصريًا في السوق. وهذا ما تفعله بعض القنوات الفضائية، إذ تقدم مادة درامية أو برنامجًا مشوقًا بشكل حصري لزيادة نسبة المشاهدة، أو لعرضه مقابل مادي، كونه غير متاح على أي قناة أخرى.
ومع أن هذه الممارسات تُعَدّ مألوفة ومقبولة على المستوى البشري، إلا أنها تصبح مزعجة عندما يتعلق الأمر بالدين. فالدين بطبيعته يفرّق بين البشر، لأن كل فرد يتمسك بما يعتقد أنه الحق الحصري. وكل دين يعلن عن نفسه بصفته المالك للحق. وعندما يتعلق الأمر بالمعتقدات، تحتل المشاعر مساحة كبيرة من المشهد، فتدفع الجماعة إلى مقاومة أي فكر أو مبدأ يخالف عقيدتها.
نعم، الدين يفرقنا، وهذا واضح في صفحات التاريخ. فمنذ البداية كان الناس يتصارعون حول معتقداتهم، إذ إن ما يؤمن به الإنسان هو ما يحرّكه ويشكل سلوكه وحياته. لذلك سعى الإنسان منذ القديم إلى نشر فكره وديانته ليضمن لنفسه الأمان والسلطة والسلام الاجتماعي، وليهاجم كل من يخالفه في المعتقد، حفاظًا على نمط حياته، أياً كان هذا النمط.
ومن هذا المنطلق نشأت الحروب بين البشر؛ فمعظم الحروب في العصور القديمة كانت في جوهرها حروبًا دينية، حيث اعتُبرت صراعًا بين آلهة متنافسة. وكان النصر أو الهزيمة في النهاية يُنسب إلى الإله الذي يعبده المنتصر أو المهزوم.
استراتيجيات إبليس
وبالطبع استخدم الشيطان عبادات الأمم الوثنية لإشعال الحروب وتمزيق البشر، لأنه كان “قاتلًا منذ البدء” (يوحنا ٨: ٤٤). فكل عبادة وثنية يقف خلفها إبليس وجنوده، وكل ديانات الحروب والنزاعات تحركها روح الشر الذي هو الشيطان.
ولذلك جاء رد فعل الإنسان على دموية الحروب بفلسفات تحاول توحيد الأديان وإخراج العبادات من دائرة الصراع البشري، بدعوى ضرورة قبول الآخر في معتقده، سعيًا وراء السلام العام والاستقرار العالمي.
لكن لهذه الفلسفات استراتيجيات خطيرة يشير إليها الرسول يوحنا في هذا النص. أولى هذه الاستراتيجيات هي إضعاف الدين والحد من انتشاره، بل محاولة القضاء على فكرة الدين من جذورها. غير أن الإلحاد والحركات العلمانية، رغم سعيها لمقاومة الدين، لم تنجح في ذلك، إذ لا تزال الأديان تنتشر ويزداد عدد المنتمين إليها يومًا بعد يوم. ولهذا، فإن هذه الاستراتيجية ليست ناجعة ولا مؤثرة بقدر الاستراتيجية الثانية.
تحذير يوحنا
ونجد صدى لهذا التوجه في العدد الأول من رسالة يوحنا الأولى (٤: ١):
أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ، لَا تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ ٱمْتَحِنُوا ٱلْأَرْوَاحَ: هَلْ هِيَ مِنَ ٱللهِ؟ لِأَنَّ أَنْبِيَاءَ كَذَبَةً كَثِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ.
هنا يحذر الرسول يوحنا من الأرواح الشريرة؛ فالمسألة ليست مرتبطة بالأنبياء الكذبة أنفسهم أو بثقافاتهم وأفكارهم فقط، بل بما يقف وراءهم من روح كاذب ومضلِّل. فالدين ليس مجرد فكر بشري محايد، بل غالبًا ما يتخفى وراءه روح يريد أن يؤكد ذاته من خلال عقيدة هذا الدين.
لذلك يحث الرسول المؤمنين ألا يصدقوا كل روح، بل أن يمتحنوا الأرواح ويميزوها. لكن كيف نمتحن الأرواح؟ وفي أي نور نكشف حقيقتها؟ يجيبنا يوحنا سريعًا بأن لدينا نورًا إلهيًا عظيمًا يرشدنا إلى الطريق المستقيم:
بِهَذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ: كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجَسَدِ فَهُوَ مِنَ ٱللهِ، وَكُلُّ رُوحٍ لَا يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجَسَدِ، فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهَذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ يَأْتِي، وَٱلْآنَ هُوَ فِي ٱلْعَالَمِ. (يُوحَنَّا ٱلْأُولَى ٤: ٢-٣)
من خلال هذا التعليم يؤكد لنا الرسول يوحنا أن إيماننا المسيحي يمتاز بمرجعية واضحة ومعيار موضوعي لفحص كل تعليم. فالمسيحية ليست قفزة في الظلام ولا مجرد تجربة روحية تُعاش، كما يروّج لها الأنبياء الكذبة، بل هي حق إلهي قائم على أسس عقائدية ثابتة تُمكّن المؤمن من مواجهة أي تعليم باطل أو روح ضد المسيح. لذلك يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية بكلمة الله.
نظرة على شعارات ما بعد الحداثة
الشعار الأول: إذا كنتُ أنا أتمسك بعقيدتي باعتبارها الحق، فلماذا ألوم الآخر على تمسكه بعقيدته أيضًا؟
هذا سؤال وجيه، لكنه غير دقيق. فالرسول يوحنا لا يلوم الأنبياء الكذبة لمجرد تمسكهم بمعتقداتهم، بل يحذر من الروح الذي يقف خلف أفكارهم ويقود إلى الشرور. فالمشكلة لا تكمن في مجرد تمسّك الإنسان بإيمانه، بل في موضوع الإيمان نفسه، وهذا ما يجب أن يُمتحن ويُختبر.
ومن هنا اتجهت بعض الفلسفات الحديثة إلى محاولة إيجاد حل لمشكلة الدين عبر مسار آخر، يقوم على إضعاف الحقائق الدينية أو تخفيفها، بحجة إخماد الصراعات وإزالة الخلافات العقائدية، وبالتالي تجاوز الفروقات التي تسببت عبر التاريخ في النزاعات والحروب.
ويتم ذلك بجعل الدين أمرًا شخصيًا بحتًا، لا علاقة له بالمجتمع أو المجال العام. فالفرد قد يؤمن بما يشاء من أفكار، وهذا شأنه الخاص، لكنه يُطالَب أن يحتفظ بعقيدته لنفسه. وهكذا تُقدَّم كل الأديان على أنها جيدة طالما ظلت حبيسة الإطار الفردي ولم تُطرح كمصدر للخلاف أو الجدل.
وقد برز هذا التوجّه بقوة مع فلسفة ما بعد الحداثة، التي روّجت لشعارات تسعى إما إلى توحيد الأديان، أو إلى جعلها شؤونًا شخصية، أو إلى إضعاف مضامينها العقائدية، بهدف خلق أرضية مشتركة تذوب فيها الفوارق الإيمانية.
لقد بدأ الناس يرفعون شعارات من قبيل: “علينا أن نقبل اختلافات بعضنا البعض، وأن نقبل التنوع العقَدي أياً كان، فالمهم هو الإنسان وليس ما يؤمن به.”
لكن هنا تكمن مغالطة منطقية كبيرة؛ فالإنسان ليس كيانًا محايدًا منفصلًا عن معتقده، بل هو في جوهره ما يؤمن به. فإيمانه هو الذي يحدد هويته، ويعطي معنى لحياته، ويوجه نظرته إلى الحرية والرجاء والرضا. ولهذا يرد الرسول يوحنا قائلاً:
أَنْتُمْ مِنَ ٱللهِ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ، وَقَدْ غَلَبْتُمُوهُمْ لِأَنَّ ٱلَّذِي فِيكُمْ أَعْظَمُ مِنَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ. هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ، وَٱلْعَالَمُ يَسْمَعُ لَهُمْ. (يُوحَنَّا ٱلْأُولَى ٤: ٤-٥)
يظهر بوضوح أن الرسول يوحنا لا يقبل فلسفة ما بعد الحداثة، بل يقسم البشر إلى فريقين متمايزين: فريق ينتمي إلى الله وفريق ينتمي إلى العالم، فريق غالب وفريق مغلوب، فريق يتكلم بكلمة الله وفريق يتكلم بحكمة العالم التي يُصغي إليها العالم. وكأن يوحنا يجلس معنا اليوم في الكنيسة، ويرى ما نراه، ويسمع ما نسمعه يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن من المهم أن نفهم أن يوحنا لا يدعونا إلى رفض المختلفين من حيث الأشخاص، بل يضع هذا التقسيم ليعمّق معنى القبول. فالقبول المسيحي لا يعني أن أقبل أفكار الآخر الكاذبة وأساويها بالحق، بل أن أُقدّم له الحق الذي يحرّره. القبول الحقيقي يعني أن أُحب الآخر محبة صادقة تدفعني لأبشّره بالإنجيل الذي فيه الخلاص. فإن كنتُ أحبّه حقًا، عليّ أن أحذّره من الهاوية التي يسير نحوها، وأن أقدّمه للمسيح الذي هو الطريق الوحيد للخلاص.
إنَّ التنوع المقبول في المسيحية ليس بين المسيح والأديان الأخرى، بل هو التنوع داخل جسد المسيح نفسه، شريطة ألا يمسّ أسس الإيمان والعقيدة. فالاختلاف الذي وقع بين الرسول بولس والرسول بطرس لم يكن حول جوهر الإيمان، بل كان خلافًا عمليًا حول ممارسة الطقس (غلاطية ٢: ١١-١٤). مثل هذا الاختلاف لا يُضعف العقيدة، بل يثبتها، لأنه يُظهر أن الحق العقائدي ثابت فوق الممارسات المتغيرة.
الشعار الثاني: ينبغي أن نركز على القواسم المشتركة بين الأديان. أليس في كل دين شيء من الحق والخير؟ أليس الأهم ما نؤمن به جميعًا هو العمل الصالح، أي ما يسمى اليوم بـ الإيمان بالإنسانية؟
هذا التوجه يسعى إلى البحث عن أرضية مشتركة بين الأديان، متجاهلًا جوهر الاختلاف، أي العقيدة نفسها، لأن العقيدة هي التي تُنشئ التمايز بين الحق والباطل منذ البداية. وهنا يعود الرسول يوحنا ليؤكد أن التفرقة بين ما هو حق وما هو باطل أمر جوهري لا يمكن تجاوزه. فالإيمان لا يقوم أساسًا على عمل الإنسان أو صلاحه الذاتي، بل على عمل الله في المسيح يسوع لمجد الله وحده. كقول الرسول يوحنا:
نَحْنُ مِنَ ٱللهِ، فَمَنْ يَعْرِفُ ٱللهَ يَسْمَعُ لَنَا، وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لَا يَسْمَعُ لَنَا. مِنْ هَذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحَقِّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ. (يُوحَنَّا ٱلْأُولَى ٤: ٦)
لاحظ ما يؤكده الرسول يوحنا في قوله: «نحن من الله». فما معنى هذا الإعلان؟ وما الذي يمنحنا اليقين بأننا في الحق؟ الجواب نجده عند الرسول بولس في رسالته إلى رومية، حيث يقول:
اَلرُّوحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلَادُ ٱللهِ. (رُومِيَةَ ٨: ٦١)
فالروح القدس يشهد في داخلنا، من خلال كلمة الله، بأننا أولاد الله. فعندما نحب الكلمة ونتلذذ بالمثول في محضر الرب، يترسخ فينا هذا اليقين العميق بانتمائنا لله. ولا يوجد دين آخر أو حركة أخلاقية في العالم تدعو أتباعها لأن يصيروا أولادًا لله بالمعنى العميق الذي يعلنه الكتاب المقدس.
فالابن لا يطلب من أبيه أن يولده، بل الولادة عمل سيادي من الآب. كذلك الإيمان المسيحي ليس مجرد قناعة عقلية أو التزام طقسي بفرائض، بل هو عطية روحية بالروح القدس، الذي يعمل فينا ويولدنا ثانية للحياة الجديدة (يوحنا ٣: ٥-٨).
لذلك لا توجد مناطق رماديّة مشتركة بين المسيح وأي فكر آخر، ليس لأن كل الأفكار الأخرى مصدرها إبليس، بل أيضًا لأنه لا يمكن تطبيق مبادئ المسيح من خارج المسيح نفسه. فالذين هم في المسيح يسوع لا يملكون مبادئ مسيحية فحسب، بل أيضًا يحملون الفكر الذي في المسيح من خلال عمل الروح القدس الذي وُلدوا منه (فيلبي ٢: ٥).
ومن هنا، يستحيل أن تكون هناك مساومة بين الحق والباطل؛ لأن الإنسان إن لم يكن في المسيح، فهو عاجز بالطبيعة عن اتباع مبادئ المسيح أو تمجيد الله بأي شكل. فالإنسان الساقط، بفطرته، لا يقدر أن يمجد الله من ذاته (رومية ٣: ١٠-١٢). بل لابد أن يُولد من الروح ويُوجد في المسيح ليكون قادرًا على ذلك.
فالرب يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي مجّد الله بالكامل، ولا يمكننا نحن أن نمجد الله إلا من خلاله. لذلك، لا يوجد خلاص خارج اسمه، لأنه «لَيْسَ اسْمٌ آخَرُ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، قَدْ أُعْطِيَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ، بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَخْلُصَ» (أعمال ٤: ١٢). لاحظ أن الرسول يقول: «لَيْسَ اسْمٌ آخَرُ» (أع ٤: ١٢). وبذلك فهو يحصر الخلاص حصريًا في اسم يسوع المسيح وحده.
فالذين يسمعون كلمة الله هم الذين هم من الله، وهؤلاء يعترفون بكلمة الله بوصفها السلطة العليا والوحيدة التي تُبنى عليها أسس الإيمان. أما الذين ينشغلون بالفلسفة البشرية، فهم لا يتعاملون مع الكتاب المقدس بهذه النظرة، بل يأخذون منه ما يخدم أفكارهم الخاصة، ويسعون دائمًا للتوفيق بين آراء الفلاسفة وعلماء النفس من جهة، وكلمة الله من جهة أخرى.
ولأجل ذلك، نجدهم يقتطعون نصوصًا من الكتاب خارج سياقها اللاهوتي ليبرروا أفكارهم، بينما يتعاملون مع نصوص أخرى على أنها مجرد أحداث تاريخية منفصلة، غير مرتبطة بالوحي الإلهي أو بخطة الله للخلاص. وهكذا يُفرَّغ الكتاب من سلطته اللاهوتية ليُختزل إلى مجرد مرجع ثقافي أو تاريخي، بينما يعلنه الرسل على أنه كلمة الله الحية والفعّالة، وسلطان الحق المطلق.
الشعار الأخير: الحق نسبي، ولا يوجد حق مطلق، لذلك فالعقيدة ليست مهمة، بل الأهم هو المحبة.
لكن الرسول يوحنا، بحسب هذا المنطق، يبدو وكأنه شخص متشدد ومتحزب لعقيدته، إذ يعلن ما يناقض تمامًا هذه الفلسفة:
أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ، لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا، لِأَنَّ ٱلْمَحَبَّةَ هِيَ مِنَ ٱللهِ، وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ وَيَعْرِفُ ٱللهَ. وَمَنْ لَا يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ ٱللهَ، لِأَنَّ ٱللهَ مَحَبَّةٌ. بِهَذَا أُظْهِرَتْ مَحَبَّةُ ٱللهِ فِينَا: أَنَّ ٱللهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِكَيْ نَحْيَا بِهِ. فِي هَذَا هِيَ ٱلْمَحَبَّةُ: لَيْسَ أَنَّنَا نَحْنُ أَحْبَبْنَا ٱللهَ، بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا، وَأَرْسَلَ ٱبْنَهُ كَفَّارَةً لِخَطَايَانَا. (١ يوحنا ٤: ٧-١٠)
هنا يعلن الرسول حقيقتين واضحتين:
- الحق ليس نسبيًا، بل يقوم على عقيدة ثابتة.
- المحبة الحقيقية لا تنفصل عن العقيدة؛ فبدون الحق تصبح المحبة مجرد شعار فارغ.
ويضع الرسول تعريفًا للمحبة: “في هذا هي المحبة…”
- أولًا: الإنسان الساقط لا يعرف المحبة بطبيعته، لأنه لا يطلب الله ولا يريد أن يفهم الحق (رومية ٣: ١٠-١٢). لذلك فإن أي محاولة بشرية لتعريف المحبة خارج المسيح تقود إلى ضلال. الأنبياء الكذبة يصورون الكلمة على أنها غامضة أو غير مفهومة، فيلجأون إلى الفلسفة البشرية لإرضاء أذهان مستمعيهم، بدلًا من قيادتهم إلى نور الحق.
- ثانيًا: الله هو الذي أحبنا أولًا، إذ أقامنا معه وأجلسنا في السماويات بالمسيح (أفسس ٢: ٤-٦). خلاصنا بالنعمة وحدها، لا بأعمالنا أو مجهودنا (أفسس ٢: ٨-٩). وإن لم يختَرنا الله، فنحن باقون تحت الغضب (يوحنا ٣: ١٨). ومن دون الإيمان الذي هو عطية من الله، لا تُحسب أعمالنا صالحة، بل تبقى خطية.
- ثالثًا: محبة الله ظهرت في تجسد ابنه الوحيد، الذي قدّم نفسه ذبيحة كفارية بديلة عنّا. بهذا يتجلى أن المحبة الحقيقية هي عقيدة، والعقيدة الحقيقية هي محبة وحق. فلا يمكن أن نحب حقًا إلا إذا كنا مولودين من الله بالكلمة الحية الباقية (١ بطرس ١: ٢٣).
إذًا، لا يحتاج الناس إلى تنوع الأديان أو إلى محبة بلا عقيدة، بل يحتاجون إلى الإنجيل، إلى الحل الذي قدّمه الله لمشكلة إبليس والخطية والموت. هذا الحل ليس في الفلسفات البشرية، بل في صليب يسوع المسيح وقيامته، حيث تلتقي المحبة بالحق والنعمة بالعدل.