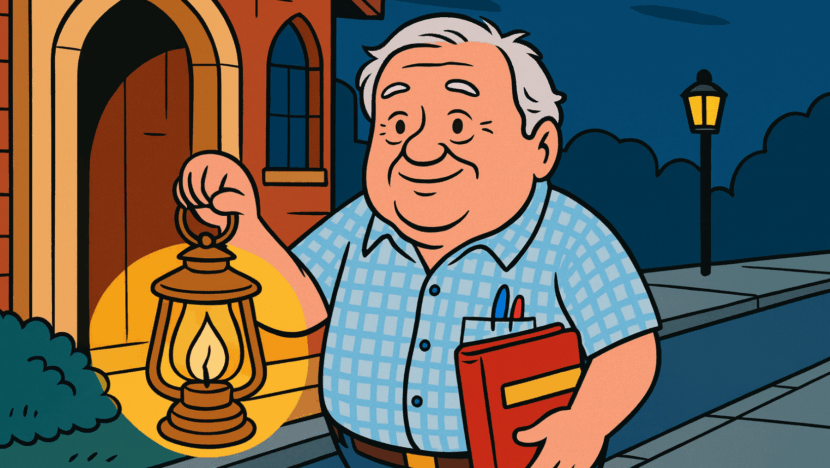لم يكن الدكتور جون فريم مجرّد أستاذٍ للاهوت النظامي يكدّس المصطلحات في قاعات الدرس؛ بل كان، قبل كل شيء، شاهدًا حيًّا على أنّ الكلمة يمكن أن تمشي في طرقات الحياة، وأن تغدو العقيدة نهجًا يوميًّا يُعاش. ففي زمنٍ اكتفى فيه الإيمان ـ في كثير من الأحيان ـ بمقاعد الكنيسة، رفع فريم لافتةً بقدر ما هي بسيطة بقدر ما هي صادمة:
اللاهوت هو تطبيق كلمة الله على يد أشخاصٍ يعيشونها في كل ميادين الحياة.
عبارةٌ قصيرة تُناقض عُقدةً قديمة في واقعنا المصري: الانفصام بين ما نرتّله داخل الكنيسة وما نمارسه خارجها؛ نحن نُجيد الوجدان الديني في الاجتماع، لكنّنا نتعثّر حين يأتي دور الشهادة والكرازة، ونعيش ازدواجيةً مُنهِكة بين قداسةٍ موسمية وبراغماتيةٍ يومية تُساير العالم.
حين نبحث عن “المعرفة العميقة بالله”، نلجأ إلى الدراسة اللاهوتية، لكن سرعان ما تظهر الهوّة بين قاعة الدرس والرصيف: لغةٌ عالية من جهة، وتحدياتٌ معيشية من جهة أخرى. منظور فريم ينقل ثقل اللاهوت من “تكديس المفاهيم” إلى “تنزيل الكلمة على الأشخاص والوقائع”، فيصبح اللاهوت جسرًا بين النص والواقع، لا جدارًا يعزل أحدهما عن الآخر.
الإعلان الحيّ
من هنا يبدأ فريم من قلب الإعلان: ربوبيةُ الله ليست فكرةً معلّقة في الهواء، بل حقيقةٌ كاشفة لِما يجري في التاريخ والضمير. اسمُ “أهيه” في العليقة ليس تعريفًا فلسفيًا باردًا، بل إعلانًا عن الكائن الحاضر الذي يأمر ويُطاع ويخلّص ويُقدِّس.
بهذا المعنى لا توجد “درجاتٌ وسط” بين الخالق والمخلوق: الله ليس نسخةً فائقة من الإنسان، ولا الإنسان نسخةً مصغّرة من الله؛ الفارق كيفيٌّ وجوهري، ومع ذلك يحمل الإنسان شبهًا وصِلةً لأنّه خُلق ليشبه الله في الطاعة والقداسة.
والربّ ربُّ العهد: يشكّل مع شعبه علاقةً عهديةً خاصّة، ومع ذلك تبقى البشرية كلّها مطلوبةً للطاعة، لأن دعوة الخلق الأولى هي خدمة الربّ السيد. وما يشهد به الضمير أن في داخل الإنسان معرفةً ما بالله وبطبيعةٍ من صفاته، يجعل الكلّ تحت مسؤولية الاستجابة، لا سيما حين يتكشّف للعيان أنّ الربوبية تعمل بثلاثة أبعاد متلازمة: سلطانٌ يأمر، وحكمٌ ينجز ويُسيطر، وحضورٌ ينخرط ويُحيي. هذه الأبعاد لا تقف منفصلة؛ فحضور الله يقتضي سلطانه، وسلطانه يفترض حكمه، وحُكمه يعني حضوره الفاعل في التاريخ والقلوب.
المنظورات الثلاثة
وعند هذه العتبة يدخل فريم إلى فكرته المنهجية الأشهر: “المنظورات الثلاثة”. كل معرفةٍ صادقة، وكل طاعةٍ أمينة، تتكوّن من:
- منظورٍ معياري يخبرنا بما يأمر به الله ويعلنه في كلمته.
- ومنظورٍ ظرفي يقرأ الواقع والوقائع كما هي بكل تعقيداتها
- ومنظورٍ وجودي يواجه الشخص في أعماق إرادته، ومشاعره، ودوافعه، وضميره.
هذه ليست بوّاباتٍ متنافسة؛ إنها عدساتٌ متداخلة. قد تبدأ من المعيار فتجد نفسك محتاجًا إلى الحالة لتُنزل الوصيّة على الأرض، ثم إلى القلب كي تتحوّل المعرفة إلى طاعة. أو تنطلق من أسئلة “الأنا” فتكتشف أنّك بلا فهمٍ لبيئتك ومعيارٍ يقودك ستبقى دائرةً حول ذاتك.
وعلى هذا القياس يقرأ فريم الثالوث نفسه: الآب يرسُم المشيئة ويرفع السلطان، والابن يُنجز ما شاء الآب ويُظهر الحكم والسيطرة، والروح يُطبّق ويُحضر الثالوث إلى القلوب والواقع حضورًا مُحييًا؛ ليس لحصر الأقانيم في أبعادٍ منفصلة، بل لإيضاح التناظر: الإله الواحد المثلّث الأقانيم يهبنا إطارًا يربط بين العقيدة والمنهج والمعيشة.
الثوالث
ولأن فريم يحبّ تحويل النظريات إلى أدوات تشغيل، فهو يعيد صياغة العقائد الكبرى في “ثوالث” Triperspectivalism عملية تساعد المعلم والخادم. فالربوبية تُرى سلطانًا وحكمًا وحضورًا؛ والمعرفة تُقرأ معياريًا وظرفيًا ووجوديًا؛ والإنسان على صورة الله يتجلّى نبيًّا وملكًا وكاهنًا؛ والأخلاق المسيحية تُفهم من خلال الأمر والسرد والفضيلة؛ وعمل الكنيسة يُوزن بالعبادة والإرسالية والمحبّة/الرعاية.
ليست هذه قوائم حفظ، بل مفاتيح لقراءة النص والحياة والقلب معًا. ومن هنا يتقدّم فريم إلى الدفاعيات كخدمةٍ موجهة لغير المؤمنين وللمؤمنين الذين يحتاجون إلى صياغة رجائهم. وتُصاغ الدفاعيات بمنطق المنظورات عينِها:
- معياريًا، تنطلق من سلطان الكلمة، فلا تقبل وهم “الأرض المحايدة” التي يُنحّي فيها الإعلان جانبًا؛
- وظرفيًا، تواجه اللادينية وتُفكك تناقضاتها بأدلة ووقائع وحججٍ تُظهر أنّ المشكلة ليست نقص المعلومة بقدر ما هي تمرّد الإرادة؛
- ووجوديًا، تخاطب الشخص بقصته وأسئلته وجراحه، وتطيل الأناة لأن الاقتناع العقلي لا يغني عن عمل الروح في التجديد.
بهذا التوازن، لا تعود محتاجًا للاصطفاف في خندقٍ ضد آخر بين “كلاسيكي” و”إثباتي” و”سبق افتراض”، إذ يمكن أن يجتمع الصحيح منها تحت رايةٍ واحدة ما دمت لا تساوم على مركزية الكلمة.
وعلى صعيد الأخلاق، يعيد فريم طرح السؤال في صيغةٍ عهدية: ما الذي يُرضي الرب؟ ليست الأخلاق تقاليد اجتماعية، ولا قوانين بلا قلب، ولا منفعةً براجماتية؛ بل طاعةٌ كتابية تصدر من قلبٍ مُطهَّر بالإيمان، وتُمارَس على طريقة الله المعلَنة، ولغايةٍ واضحة هي مجده.
ومن ثمّ يصبح الحكم الأخلاقي عملًا ثلاثيّ العدسات: المعيار يقود، والظرف يُوازن ويقرأ التعقيد، والوجود يفتّش الدوافع والضمير ويشكّل الفضيلة. عندئذٍ تنهار الثنائية الزائفة: القانون ضد المنفعة؛ فالقانون بلا قلبٍ يُفضي إلى رياء، والمنفعة بلا معيارٍ تنتهي إلى تسيّبٍ أخلاقي. التكامل وحده يجعل الطاعة فرحةً ومسؤولةً وحكيمة.
أمراض الواقع المصري
وعندما نضع هذا المنهج أمام واقعنا الكنسي والمجتمعي في مصر تتبدّى لنا الأمراض القديمة في ضوءٍ جديد. هناك ثنائية الكنيسة/الشارع: نجيد اللغة الكنسية لكننا نخفق في إنزالها إلى الجامعة، والوظيفة، والمنزل، والإعلام.
علاج فريم أن تتحوّل العظة والدروس إلى مسارٍ عملي يبدأ بالسؤال: ماذا يأمر الرب؟ ثم: ما حالنا الواقعية؟ ثم: كيف أستجيب أنا اليوم؟
وهناك مأزق الانعزال عن قضايا الناس أو الذوبان في ثقافة اليوم على حساب سلطان الكلمة؛ المنظورات الثلاثة تمنحنا طريقًا ثالثًا: معيارٌ لا يُساوَم عليه، تنزيلٌ ظرفيٌّ حكيم، وخطابٌ وجوديٌّ رحيم.
ثمّ جدل “الحق أم المحبة”: فريقٌ يرفع الحقّ دون وداعة، وفريقٌ يرفع المحبة دون معيار. والمنهج يوضّح أنّ الحق وصية، والمحبة وصية، والتأديب تطبيقٌ ظرفيٌّ للمحبة لا نقيضها، والوداعة تشكيلٌ وجودي لا ضعفًا.
وتبقى معضلة الكرازة حين تُختزل في أرقام الحضور: حملاتٌ ضخمة بلا زرعٍ لكنائس محلية تتلمذ وترافق الناس وجهًا لوجه. هنا يذكّرنا تعريف اللاهوت نفسه بأن الرسالة لا تنتهي على المنصّة، بل تبدأ في الأحياء والجامعات وأماكن العمل حيث تُغرس جماعاتٌ صغيرة، ويُنقَل الإنجيل من مقاعد المناسبة إلى “نسيج الحياة”.
أمّا الالتباس حول “المعرفة الفطرية بالله”، فيحتاج إلى تدقيق: نعم، لدى البشر معرفة ما بالله تُسقط العذر، لكنها لا تخلّص؛ الخلاص عطيةٌ في المسيح تُستقبل بالإيمان، والتجديد عملُ الروح، والمعرفة العقلية خادمةٌ أمينة لا بديل عن القلب الجديد.
المسارات العملية في منهج فريم
وحتى لا يبقى الكلام شعارات، يقترح المنهج مساراتٍ عملية. تبدأ أولًا بإعادة هيكلة العظات والدروس على الإيقاع الثلاثي: معيارٌ كتابي واضح، قراءةٌ دقيقة للظرف المصري في البيت والجامعة والعمل والشارع، ثم دعوةٌ وجودية لاستجابةٍ عملية اليوم لا غدًا.
وتمتدّ إلى الدفاعيات العملية التي تجمع بين الصرامة الكتابية والرشاقة في الحجّة والرحمة بالمعاندين والمترددين؛ إلى الأخلاق التي تعيد صياغة الأسئلة من “ما الشائع؟” و”ما المفيد لي؟” إلى “ما الذي يأمر به الرب؟” و”ما آثار قراري واقعيًا؟” و”هل قلبي يطلب مجد الله أم راحتي؟”.
وتتسع الرؤية إلى تبنّي مفهوم “المملكة الواحدة”: لا مجالات محايدة خارج سيادة الرب؛ المهنة والفنّ والاقتصاد والسياسة ساحاتُ عبادةٍ وطاعة، والانسحاب ليس تقوىً، كما أن الذوبان ليس انفتاحًا. ومن أجل تحويل “الثوالث” إلى أدوات تدريبٍ فعّالة، يمكن تكوين القادة على طرح أي قضيةٍ عبر عدسات المعيار والظرف والوجود، وبناء كتيّبات تَلمَذة قصيرة لكل ثلاثية (كالإنسان نبي/ ملك/ كاهن) مع تمارين تطبيق أسبوعية، وتطوير ممارسة رعوية تجعل التأديب مزيجًا من وضوح المعيار، وفهم الملابسات، واحتضان الشخص.
ولكي تزداد الصورة ملمسًا واقعيًا، تخيّل طالبًا في الجامعة يتعرّض لسخرية بسبب إيمانه: المعيار يدعوه إلى عدم الخجل بالإنجيل والشهادة الأمينة، والظرف يُعرّفه ضغوط منصّات التواصل والسياق الفكري السائد وكيفية التعامل معهما بحكمة، والوجود يحرّكه لتدريب نفسه على جوابٍ هادئ ويبحث عن جماعة دعمٍ ويثابر في الصلاة والشركة.
أو موظفًا في بيئة عملٍ تُشجّع التحايل: المعيار يناديه إلى الأمانة والعدالة، والظرف يكشف له أن نظام الحوافز قد يغري بالالتفاف، والوجود يأخذه إلى قرارٍ فعليّ يرفض الغشّ ويطلب مشورة ويبتكر حلولًا تحفظ نزاهته ورزقه.
أو خدمةً كرازية في حيٍّ شعبي: المعيار يفرض وضوح الإنجيل دون مساومة، والظرف يُلزم بمواجهة الفقر والتهميش بخدمة رحمةٍ حقيقية موازية، والوجود يدعو إلى زرع مجموعةٍ محلية صغيرة تنقل الناس من لحظة الحماسة إلى مسيرة التشكيل.
تتكامل هذه الخيوط في خاتمةٍ واحدة:
إن طرح فريم يصلح لزمننا لأنّه يعيد مركزية الرب في كل قرارٍ صغير وكبير، ويكسر الثنائيات المزيّفة -علم مقابل إيمان، عقل مقابل قلب، حق مقابل محبة، عقيدة مقابل حياة- ويقدّم أدوات تشغيلٍ واضحة تُترجم الإيمان إلى اختياراتٍ ملموسة. ليس “لاهوت التطبيق” امتلاكَ معجمٍ أوسع، بل اختبارُ طاعةٍ أعمق: نسمع كلمة الرب، نقرأ واقعنا في نورها، نستجيب بقلوبٍ تُجدّدها النعمة. عندئذٍ تزول الازدواجية، ويُشفى الانفصام بين الكنيسة والشارع، ويظهر الإنجيل، لا كعنوانٍ على ملصق، بل كحياةٍ تُعاش. وإذا كان اللاهوت تطبيقَ كلمة الله بواسطة أشخاصٍ في كل الدوائر، فليس أمامنا إلا أن نبدأ الآن.